ثقافة شذرات تاريخية عن التراث الموسيقي المشترك عند العرب والقدرة العلاجية للموسيقى منذ القدم، وعن حبس العود والرباب لـ"عزيزة عثمانة"
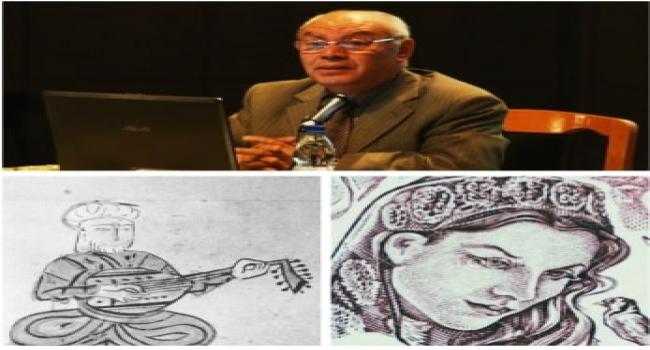
نظّم بيت الحكمة ندوة فكرية ثقافية بعنوان " المشترك في التراث الموسيقي العربي الإسلامي"، أثّثها الدكتور محمود قطاط وهو أستاذ تعليم عالي متميز بالموسيقى والعلوم الموسيقية بجامعة تونس والمحدث لاختصاص العلوم الموسيقية بالتعليم العالي التونسي، ومؤسس المعهد العالي للموسيقى بتونس...
وفي هذه الندوة التي تم تنظيمها سابقا تحديدا بقسم الفنون بالمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون، شدّد الأستاذ محمود قطاط في بداية محاضرته على أهمية علم الموسيقى باعتباره علما شاملا يخضع في أساليبه وتقنياته الى مجالات عدة وعلى الدور الفعّال للفن الموسيقي في تاريخ الحضارة والشعوب، مضيفا بأن تاريخ الموسيقى يشهد قفزة نوعية وذلك على إثر اكتشاف عدد من المخطوطات والشواهد الأثرية فضلا عن توسّع المسوحات الميدانية وما تبع ذك من بروز دراسات تحليلية مقارنة...
ما حكاية تعصّب الدوافع العقائدية الشعبوية والسياسية الإيديولوجية؟
وحول البحث في موسيقى الحضارة العربية الاسلامية، شدّد قطاط بأنّ هذه المسألة تزداد مشقة بسبب وفرة الروايات المتضاربة التي تزخر بها المراجع القديمة والحديثة وهي تتضمن تعميمات وافتراضات تعود أساسا إلى تعصّب دوافع عقائدية شعبوية واخرى سياسية إيديولوجية تسبّب تأويلها في العديد من الاستنتاجات الخاطئة التي أضحى بعضها من المسلمات وهو ما يمثل باعتقاده السبب الرئيس لانزلاق عدد من المؤرخين والباحثين في المجال الموسيقي في متاهات من الخلط والالتباس مايزال يعاني منهما تاريخ الموسيقى بل وتاريخ الحضارة العربية الاسلامية عموما على حدّ تعبيره...
وذكر الدكتور قطاط بعض النماذج الموسيقية التاريخية من بينها تلك التي برزت في فترتين منفصلتين ما قبل الإسلام وكانت عبارة عن (أناشيد بدوية لا يعرف منها الا نمطي الحداء والخبب).
وما بعد الإسلام، حيث لم تكن الموسيقى العربية نظريا سوى موسيقى إغريقية أمّا عمليا فكانت عبارة عن موسيقى فارسية، منوّها الى الاعتقاد الذي كان يقول إنّ كل المبادرات الموسيقية قد ظهرت انطلاقا من صدر الإسلام وكأنه قبل ذلك لم تكن هنالك موسيقى علاوة على التركيز المتعمد على الصفة العرقية أو العقائدية لكبار العلماء القدماء أمثال "الكندي والرازي والفرابي وابن سينا وغيرهم فهم إمّا عرب أو فرس أو أتراك أو أذريين وغيرهم وذلك تبعا لأهواء عدد من المؤرخين على حد تعبيره.
وحول الحديث عن التراث الفكري للحضارة العربية الاسلامية وعدد المخطوطات العربية الموسيقية التي تحتويها الخزائن الاجنبية في العالم، يؤكد المحاضر انه وعلى إثر تصفّحه للفهارس القديمة التي رصدت هذا التراث الفكري خاصة خلال القرون العشرة الأولى تبيّن إحصاؤها بآلاف العناوين من الكتب والرسائل التي ألّفها عدد من المبدعين والنوابغ في شتى أصناف العلم والمعرفة، مشيرا إلى أنّ الانسانية بقيت شاهدة على ما حققه أصحاب هذه المؤلفات من نتائج غير مسبوقة كانت فاصلة في تقدّمها على أسس البحث العلمي وفنون التجربة والاختبار مما جعلها حينها منارة للحضارة الإسلامية...
وأعرب في المقابل عن أسفه من ضياع كمّ هائل من هذا التراث الضخم بسبب الحروب والغزوات المتتالية وحملات التخريب والتدمير المتعاقبة والتي كان نصيب المكتبات من الحرق والنهب منها فادح وكبير...
3 ملايين مخطوط عربي موسيقي بالخزائن الأجنبية
وأكّد محمود قطاط بأنّ عدد المخطوطات العربية الموسيقية التي تحتويها الخزائن الأجنبية في العالم تقدر بنحو 3 ملايين مخطوط، وأنّه داخل هذا الإنتاج الضخم تبوّأ موضوع الموسيقى والعلوم الموسيقية مكانة مرموقة وعُرف تبعا لذلك من النظري الى العمليّ كمّا وافرا من المصنفات جاءت متعددة المشارب متسعة الأفاق منها ما اتخذ وجهة نظر علمية وفلسفية ورياضية وفلكية ومنها ما جاء أكثر قربا من الواقع العملي وهو الذي اهتم به مبدعون معنيون بالصناعة الموسسيقية جمعوا بين التنظير والتطبيق...
وأضاف الباحث أنّ هذه المصنفات الموسيقية عدّت بأكثر من 650 عنوانا وصل منها حوالي 360 واحتواها ما يقارب 1265 مخطوطا دون اعتبار المفقود منها، إلى جانب أمهات الكتب ذات المواضيع المتنوعة والمتداخلة من ضمنها كتب الإخبار والأدب والتراجم والرحلات وكتب الفقه والتصوّف والفلسفة وكتب المعاجم المختلفة والدواوين والمجاميع الشعرية وغيرها...
وبيّن المتحدّث بأنّه لا يمكن تحديد ملامح التراث الموسيقي وإبراز تفرعاته من ضمنها الموسيقى العربية دون الانطلاق من نظرة شمولية تتناغم تماما مع البعد الكوني، حيث أنّنا أمام نظام موسيقي استمد مكوناته على مرّر العصور من إفرازات عدة تتجاوز مرجعياتها العرب والفرس والأتراك كما تختزل عادة روافد محلية تحاكي نسيجا اجتماعيا فسيفسائيا رائع التداخل والتكامل ساهم في ارساء هذا النظام الموسيقي واثرائه لتبرزه في تشكيلة مقامية ثرية متجانسة ومتباينة في نفس الآن.
العلاج بالموسيقى في كتب العلامات...
ويضيف المحاضر بأنّ الموسيقى كلغة وعلم وصناعة وفنّ ترمي قبل كلّ شيء إلى السموّ بالأرواح الى عالم القدسية وهي واسطة بين الإنسان والعالم العلوي، معتبرا أنّ قوتها السحرية والعاطفية والعلاجية عظيمة نسبها أغلب المنظرون لأوتار العود إلى جانب المقامات والإيقاعات مشدّدا على توفّر مراجع عدّة في هذا الإطار منها "كشف الظنون" للحاجي خليفة والذي تضمّن تفاصيلا متعلّقة بالمعالجة بالموسيقى وقد شمل نواحي كثيرة من نظريات الطبّ والموسيقى والعلاقات الرابطة بينهما.
ويتابع محمود قطاط مداخلته قائلا إنّ علاقة الموسيقى بالطبّ والتداوي حضيت باهتمام كبير من العلماء المشاهير من بينهم "الكندي، الرازي، ابن سينا، ابن الهيثم ، وابن زهر وابن رشد...) وتبعا لذلك تمّ توسيع وتطوير النظرية التي يعتقد بموجبها بوجود أربعة أخلاط في الجسم البشري (الدم، الصفراء، السوداء، البلغم) مشابهة للعناصر الكونية الأربعة (الأرض والهواء والنار والماء) مع تصوّر وجود أربع خصائص للمادة (الحرارة والجفاف والرطوبة والبرودة) مع التأكيد على أهمية عنصر البيئة أي المناخ والواقع الجغرافي في تفسير نوعية الموسيقى والأنظمة الموسيقية الخاصة بالمجموعات والامم المختلفة وما بينها من الفوارق الطبيعية من الأمزجة والسلوك والأذواق والعادات والتصورات...
واعتبر قطاط أنّ هذه العلامات الفارقة ليست نتيجة وراثية بل سببها البيئة والمناخ، فالموسيقى كما يصفها ابن هند في القرن الحادي عشر هي من "العلوم التي يجب على الطبيب أن يعرفها كي يكون كاملا في صنعته مستعينا بأساليب موسيقية تنسجم مع حالة المرض لعلاجه وشفائه"..
الموسيقى لقوم كالغذاء ولقوم كالدواء...
وتطرّق الأستاذ قطاط إلى ما ورد في إحدى قصص ألف ليلة وليلة " الموسيقى لقوم كالغذاء ولقوم كالدواء "، كما جاء في كتاب المستطرف في كل فن مستظرف للكاتب شهاب الدين محمد الأبشيهي "زعم أهل الطبّ أن الصوت الحسن يسري في الجسم ويجري في العروق فيصفو له الدمّ ويرتاح له القلب وتهشّ له النفس وتهتزّ الجوارح وتخفّ الحركات"..
ونوّه المتحدّث للأهمية الكبرى التي أولاها العالم ابن سينا للموسيقى ولتقديره لقدرتها العلاجية وهو ما خصّصه في مصنّفات تعتني بهذا الجانب من بينها موسوعته "القانون في الطبّ"، معتبرا انّه ورغم دحضه لنظريات ربط الموسيقى بالتنجيم والكونية إلّا انّه يعمّق النظر في العلاقة الخاصّة بينها وبين الطبّ وهي علاقة تواصلت وتكرّرت شرقا وغربا الى حدود القرن التاسع عشر.
علاقة الطبّ النفسي بالموسيقى
أمّا عن علاقة الموسيقى بالطب النفسي، أبرز محمود قطاط بأنه قد تم الإنتباه لقدرة الموسيقى في مداواة بعض الأمراض النفسية والعصبية والعقلية، مشدّدا على براعة سينا نظريا وعمليا في هذا الشأن حيث أنّه كان أول من تكلم عن الطب النفسي الجسدي وطبّق مبادئه وأساليبه في المعالجة ورأى أن الموسيقى هي أسلوب علاجي مهمّ ومؤثر في الامراض العقلية.
وأضاف في ذات السياق بأنّ من بين العلماء المشاهير الذين اهتموا بالجانب العلاجي للموسيقى للأمراض النفسية والعصبية الرازي والذي كان موسيقيا وعازفا بارعا على آلة العود، ومؤمنا بفائدة الموسيقى في شفاء الأمراض وتسكين الآلام واعتمدها في العلاج الطبي وأوصى بها كأسلوب هام من أساليب علاج الأمراض النفسية والعصبية والعقلية وقد حقّق نتائج ملحوظة بفضل التجارب التي قام بها...
تأثير الأنغام والألحان على سلوك الحيوان وسيكولوجيته
وأشار قطاط في ذات السياق بأنّ المعالجة النفسانية بالموسيقى لعبت آنذاك دورا هاما في مداواة الآلام الجسدية ووضعت لها العديد من المؤلفات الخاصة ككتاب "تأثير الموسيقى في الإنسان والحيوان" للعالم الفيزيائي ورائد العلم التجريبي الحديث ابن الهيثم ويعدّ هذا الكتاب أقدم مخطوطة تتعامل مع تأثير الموسيقى على الحيوانات أو تأثير الأنغام على أرواح الحيوانات وضرب فيه كاتبه أمثلة حول كيفية تأثير الأنغام والألحان على سلوك الحيوان وسيكولوجيته وقد أجرى تجاربه على الطيور وعلى الخيول وعلى الزواحف.
تأثير الذبدبات الصوتية على الكائنات الحيّة
وأكّد الباحث قطاط انّه وإلى غاية القرن التاسع عشر اعتبر معظم العلماء انّ الموسيقى لها تأثير واضح على ظاهر الإنسان إلى أن أثبتت التجارب وأيّدت وجهة نظر ابن الهيثم لما للموسيقى من تأثير واضح على الحيوانات أيضا بل وقد بيّنت الأبحاث لاحقا كيف أنّ للذبذبات الصوتية تأثير لا على الانسان فحسب بل وكذلك على الكثير من الكائنات الحيّة، مبيّنا ما ذهب إليه المختصون في علم موسيقى الحيوان من اعتبارهم بأنّ علم الأحياء الموسيقي هو شأن كونيّ...
ويضيف المتحدّث "جانب آخر حريّ بالإشادة في هذا الاطار هو مسألة الترييض الموسيقى الذي يجمع مسألة ترييض الجسم والنفس ونشير هنا الى كتاب طب المشائخ وحفظ صحتهم للطبيب أحمد ابن الجزار القيرواني والذي جاء فيه "لقد صحّ عندي بأن الموسيقى والرياضة ملائمان ومربيان للطبيعة والذي يمكنه استعمال هتين الصناعتين استعمالا جيدا فإنّه يورث بدنه أدبا ونفسه حسنا وسلامة""..
"حبس العود والرباب" لعزيزة عثمانة
واعتبر الأستاذ انّ مختلف التوجهات المتعلّقة بترييض الموسيقى لم تكن مجرد تنظير بل واكبتها تطبيقات وتجارب ملموسة وصلت أخبارها حتّى القرن 19، وهنا ذكر مثالين تونسيين الأول تمّ خلال الدولة المرادية وهو ما يعرف بـ"حبس العود والرباب" الذي رتّبته او خصّصته الأميرة عزيزة عثمانة كجراية لمطربين ماهرين يقومون صباح كلّ يوم بدار الدراويش بعزف نوبة من موسيقى المالوف باستعمال آلتي العود والرباب وذلك لمدة ساعتين لتهدئة المرضى حيث كان بدار الدراويش قسم خاص معد لإيواء المصابين باختلال الأعصاب..
دور الموسيقى في تشخيص المرض وسوق الأطباء بمدينة تونس العتيقة
كما ذكر قطاط في ذات المنحى مثالا متعلّقا بدور الموسيقى في تشخيص المرض، مؤكدا أنه خلال العصر الحسيني ونقلا عن ابن أبي ضياف حول سوق الأطباء بمدينة تونس العتيقة كان إذا ما ذهب مريض أدخله الطبيب الى مقصورة في عيادته وأسمعه "الطبوع الأصول" وأثناء متابعته لمريضه في حال السماع وإذا ما حركّه طبع منها شخّص الطبيب طبيعة مرضه وعرف بذلك ماهية العلاج.
التوجّه الجمالي الأنثروبولوجي للموسيقى
وفي الانتقال الى الحديث عن التوجّه الجمالي الأنثروبولوجي للموسيقي، أكّد الدكتور قطاط أنّه وبالرجوع الى كتابات الفرابي على وجه التحديد "المدخل" وكذلك الخاتمة في كتابه "الموسيقي الكبير" يمكن استنطاق واستخراج نظرية فلسفية جمالية تتسم بشموليتها وعمقها الى رحاب علم الإناسة الموسيقي..
ويتابع قائلا "وإذا ما وضعنا استنتاجاته في سياق ما كتب في تاريخ الجمالية الموسيقية وكذلك ماهو مطروح في سياق انثروبولوجيا الموسيقى نلاحظ تطرّق الفارابي الى عديد القضايا المطروحة بمقاربات وشروحات موسّعة لعدد من القضايا نذكر منها 7 عناوين وهي أولا ما معنى صناعة الموسيقى، ثانيا كيف استحدث الانسان الموسيقى ولأيّ غرض؟ ثالثا موسيقى الانسان وموسيقى الطبيعة، رابعا أسبقية الموسيقى العملية على صناعة الموسيقى النظرية، خامسا استجابة الانسان للموسيقى وماذا تعني له، سادسا ثنائية المبنى والمعنى أي أصناف الألحان وغاياتها ومدخلها في الانسانية وماهي مجالات تعبيرها وسابعا نسبية معايير الجمال تبعا للتنوع الموسيقي والثقافي والتذوق الفني "...
المشترك من خلال الصناعة الموسيقية نظريا وعمليا
وعن المشترك من خلال الصناعة الموسيقية نظريا وعمليا، شدّد الأستاذ المحاضر على اعتبار العود كآلة مرجعية للمقامية العربية الإسلامية، معتبرا أنّ مرجعية هذه الآلة الموسيقية تتمثّل خاصّة في معالجة الصناعة الموسيقية في مختلف تطلعاتها وشرح نظرياتها ودراسة أبعادها الفيزيائية والفلسفية والعلاجية حتّى قيل إنّ معرفة العود ونسب دساتينه هو من تمام علم الموسيقى وعلى هذا الاساس اعتبر العود آلة رمزا لإرساء أصول المقامية العربية الاسلامية مما جعله دعامة هامة لبلورة عناصر المشترك في الصناعة الموسيقية العربية الاسلامية .

وأوضح قطاط بأنّ آلة العود تقوم في نفس الآن بالعديد من الوظائف فهي عبارة عن مخبر للبحوث النظرية كما انها تعدّ مرجعا للدراسات المشاركة (موسيقية فلسفية، موسيقية جمالية...) وتمثّل كذلك وسيلة عملية تستعمل للتلقين وللتدريس وكذلك لطرق الآداء ودقّة العزف ومساوقة الغناء وللإبداع والتلحين ..
ويتابع قطاط بأنّ أهمية آلة العود تأكدت منذ صدر الإسلام ومع فترة الأمويين تحديدا حيث احتلّ مكانة الصدارة وقد استخدمه المحترفون للمسايرة واستخدمه الرواد الأوائل لاعتماد أسس تنظير موسيقاهم باعتباره أتم وأحسن ما صنع من الآلات، وهو كما يفيد الفارابي من "الآلات الوترية المألوفة منذ القدم عند الأمم الشرقية لا تضارعها آلة أخرى " وهي آلة كما يقول الكندي "ليس فيها شيء إلّا وفيه علّة فلسفية إمّا هندسية وإما عددية وإما نجومية"...
وأكّد المحاضر أنّه وبالرجوع الى مختلف الشروحات التي وردت في شأن العود تبيّن بأنّ هذه الآلة تمثّل الأداة المرجعية لمن يريد التعرّف على جلّ التوجهات التي اتبعتها موسيقى هذه الحضارة وهو ما بيّنه في كتاب خصصه للغرض بعنوان "آلة العود بين دقة العلم وأسرار الفن"...
قالب النوبة
وفي ذات الحديث عن التراث الموسيقي المشترك، شدّد قطاط على أنّ الغناء بطريقة النوبة يعتبر كذلك من التراث المشترك معتبرا أنّه يمثّل نموذجا للوحدة والتنوع في التراث الموسيقي العربي الإسلامي حيث أنّ ملامح المشترك تتضح من خلال أساليب الأداء ويتجلّى ذلك مثلا من خلال النماذج المتنوعة لإلقاء الآذان وترتيل القرآن الكريم وتجويده في كل بلاد العالم الاسلامي، وكذلك في هيكلة قوالب الرصيد الكلاسيكي التقليدي الدنيوي منه والصوفي والتي تعود تاريخيا الى ما كان يعرف بالنوبة الغنائية.
وأضاف أنّ النوبة تعدّ أثرا فنيا لتقليد موسيقي كبير أفرزته مختلف الروافد المكونة للحضارة العربية الإسلامية خلال عصرها الذهبي، وتمثل نموذجا موسيقيا متكاملا عمّ استعماله في مختلف مراكز هذه الحضارة شرقا وغربا وهو ما يزال شامخا الى اليوم شاهدا على أهمية هذا المشترك وعلى عمق الوحدة والتنوع في التراث الموسيقي العربي الاسلامي من خلال مجموعة قوالب مركبة..
ويضيف محمود قطاط "كان مسرح النوبة مقتصرا على معنى التناوب أمام الخليفة من قبل الرماة والشعراء والموسيقيين حسب دور كل منهم قبل ان يتوسّع المصطلح إلى مجالات أخرى من ذلك المجال الموسيقي حيث صارت له معان عدة منها مجموعة من آلات الطرب وآلة النقر الايقاعية من فصيلة الطبل البرميلي وفرقة المغنين أو العازفين وحصة موسيقية وصولا الى قالب موسيقي مركّب منتظم"..
وبيّن المتحدّث بأنّ النوبة كقالب موسيقي أضحى لها شأن كبير في التراث الموسيقي العربي الإسلامي، حيث نجدها تشكّل عنصرا أساسيا في مختلف الأرصدة في رصيد الموسيقى العسكرية وفي رصيد الموسيقى الشعبية وخاصة في رصيد الموسيقى الكلاسيكية التقليدية الصوفية والدنيوية.
واعتبر أنّ الغناء بطريقة النوبة أفرز قالبا من أهم القوالب وأكملها وهو يتضمن عددا من القطع الآلية والغنائية التي تؤدى حسب نسق معيّن ونظام وقواعد متفق عليها، مشيرا إلى أنّ الغناء بطريقة النوبة شهد عبر التاريخ إضافات متتالية وكان له التأثير العميق في إثراء الفنّين الشعري والموسيقي وتاريخيا تعود الملامح الأولى لهذا القالب الى القرن الثاني هجري /الثامن الميلادي ثم توضحت ملامحه مع العصر الذهبي للموسيقي خلال الطور العباسي الأول قبل أن يعم استعماله في مختلف المراكز العربية الاسلامية شرقا وغربا.
واكّد الباحث محمود قطاط بأنّ قالب النوبة شهد سلسلة من التحولات غيرته عما كان عليه من قبل في كل المشرق والمغرب ويمكن حوصلة هذه التحولات في عدد من القوالب المركبة من بينها:
في البلاد العربية نجد المقام العراقي، وهو قالب يشابه النوبة، الصوت بالجزيرة العربية، القومة باليمن، والوصلة الشامية المصرية، والنوبة المغاربية، وموريطانيا ما يسمى بالأزوان وهو ما يعتمده بنو حسان في موسيقاهم الكلاسيكية ، كذلك المدرسة التركية المغولية "الفاصل التركي"...
وخلص الدكتور محمود قطاط في ذات مداخلته إلى أنّ هذا الطابع الكوني للموسيقى الموحد في أصوله والمتنوع في روافده والذي يميّز الفنون العربية الاسلامية عموما والفن الموسيقي تحديدا، يطرح مسألة وجوب إعادة النظر في مناهج البحث والدراسة ومناقشة المفاهيم المعتمدة والآراء السائدة الى حد الآن لدى بعض أهل الاختصاص من عرب ومستشرقين على حد سواء، لذلك بات من الضروري إعادة الاعتبار لهذه الفنون وإبراز تنوعها اعتمادا على نظرة علمية فنية تربطها أساسا بالواقع التاريخي والإجتماعي والجمالي للحضارة العربية الاسلامية في بعديها الكوني والانساني...
إعداد: منارة تليجاني










